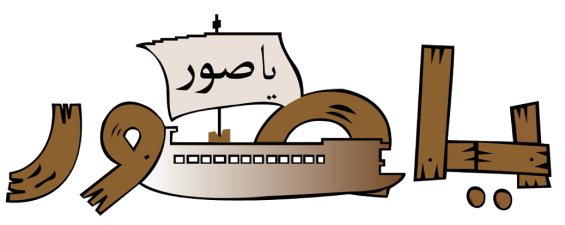«مليونيّة رفض الاحتلال» في بغداد: بدء الحراك الشعبي بوجه الأميركيّين

في أوّل المخرجات «غير العسكرية» لاجتماع فصائل المقاومة العراقية، والذي عُقد في مدينة قم الإيرانية قبل يومين، بحضور معظم قادتها، إضافةً إلى ممثلين عنهم، جاءت دعوة زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر، إلى «ثورة مليونية» تندّد بالاحتلال الأميركي للبلاد. بيان الصدر دعا إلى «ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية»، تكون أولى خطواتها «تظاهرة مليونية سلمية موحّدة تندّد بالاحتلال وانتهاكاته»، معلِناً أن هذه الخطوة ستُستكمل بـ«وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية، تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة». البيان لم يحدّد موعداً للتظاهرة المرتقبة، مُسنداً ذلك إلى «اللجنة التنسيقية» التي ستصدر بياناً في الساعات المقبلة يحدّد مكانها وزمانها، وسط ترجيحات بأن تكون في بغداد، نهار الجمعة الواقع فيه 17 كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد صلاة الظهر. أما الشعارات، فستؤكد تمسّك العراقيين بسيادتهم ووحدة أراضيهم ضدّ أيّ مشروع تقسيمي، ورفضهم أيّ وجود عسكري أجنبي يعدّ انتهاكاً لاستقلال البلاد. سريعاً، جاء الردّ على دعوة الصدر. قوى «البيت الشيعي» ــــ وتحديداً المؤيدة لـ«الحشد الشعبي» والمقاومة ــــ تبنّت موقف الرجل، ودعت جماهيرها إلى الالتفاف حوله، فيما لم يوضح زعماء «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، و«تيار الحكمة» عمار الحكيم، و«ائتلاف النصر» حيدر العبادي، موقفهم بعد. لكن التوقعات تشير إلى أن الأوّلَين سيمضيان «على مضض» في هذا الخيار، في حين سيرفض الأخير أيّ حراك مماثل لأنه «يُدخل العراق في نفقٍ مظلم»، على حدّ تعبير مقربين منه.
وعلى رغم التباين الكبير في المواقف والرؤى بين الصدر و«رفاق السلاح» السابقين من قادة الفصائل، كان بارزاً جداً تقديم الصدر كـ«أبٍ» للمقاومة العراقية، علماً بأن السواد الأعظم من قادة الفصائل هم من كوادر «جيش المهدي» و«لواء اليوم الموعود» (الأجنحة العسكرية لـ«التيار»).
استُهدف معسكر التاجي، الواقع شمالي بغداد، بعدد من صواريخ الكاتيوشا
التفافٌ يُعزى إلى جهود بُذلت منذ استشهاد نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وقائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، دفعت باتجاه «وحدة الصفّ ورصّه، ووضع الخلافات جانباً»، لأن العراق «مقبلٌ على مرحلة حسّاسة جداً ودقيقة، تفرض على قوى البيت الشيعي إزاحة الخلاف ولمّ الشمل وتصدير موقف واحد» وفق ما تعبّر مصادر مطلعة. كذلك، ثمة إجماعٌ بين معظم تلك القوى على دعم جهود رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في تنفيذ القرار البرلماني الداعي إلى انسحاب قوات الاحتلال، واعتباره «إنذاراً» للأميركيين قبل الانتقال إلى مرحلة المقاومة الميدانية. من جانب إيران، يبدو أن ثمة توجّهاً لدى القيادة هناك لاحتضان الصدر في المرحلة المقبلة، وتأكيد موقعه المتقدّم في مقاومة الاحتلال الأميركي، في ظلّ حاجة طهران إلى إعادة ترتيب أوراقها داخل بلاد الرافدين، وتنظيم فريقها العامل في العراق، والابتعاد قدر المستطاع عن أيّ خلاف من شأنه تقويض ما كان الفريق سليماني قد نجح في إنجازه.
ميدانياً، استُهدف معسكر التاجي، الواقع شمالي بغداد، بعدد من صواريخ الكاتيوشا، والتي لم تسفر عن وقوع إصابات. ومن المتوقع أن يشهد هذا المعسكر، الذي تشغل القوات الأميركية جزءاً منه، مزيداً من تلك العمليات وبما يفوقها قوة في المرحلة المقبلة، بوصفه واحداً من «بنك أهداف» المقاومة. وهو ما قرأه الأميركيون جيداً منذ حادثة الاغتيال، فعمدوا إلى تقليص حضورهم هناك، والاكتفاء بالتحركات الضرورية حرصاً على «أمن قواتهم». ويوضع استهداف الأمس في سياق «الرسائل التحذيرية» التي تحرص الفصائل على توجيهها توازياً مع الحراك السياسي، من أجل التأكيد أن الخيار الميداني خيار قائم، وهو «الأنجع لمواجهة الاحتلال»، بحسب ما تقول مصادرها.
على خطّ موازٍ، وفيما تتزايد المؤشرات إلى أن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، باقٍ في موقعه إلى «أجل غير مسمى»، بدا لافتاً تصريحه أمس، والذي قال فيه إن «العراق قوي وقادر على تجاوز كلّ الظروف الصعبة والمعقّدة... وإن علاقاته الخارجية في أفضل حالاتها»، مشدّداً على «منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة مواصلة الجهود لمواجهة بقايا داعش، وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف». تصريحات تُعدّ، وفق مصادر حكومية، دليلاً على أن عبد المهدي ــــ وعلى رغم تصريفه للأعمال ــــ سيتعامل مع الاستحقاقات والتحدّيات بصفته «أصيلاً»، وسيكمل مهماته حتى التوافق على بديل.
واشنطن وحلفاؤها أكبر المتضرّرين اقتصادياً: ماذا لو وقعت الحرب؟
قد تكون هناك مبرّرات سياسية وأيديولوجية كثيرة لاتخاذ قرار الحرب، لكن في المقابل ربما يكفي مبرّر اقتصادي واحد لتجنّبها. فهل تكون المصالح الاقتصادية في المنطقة سبباً كافياً لنزع فتيل حرب مدمّرة؟ أم ستكون هي الحرب نفسها؟
تبدو المنطقة اليوم أقرب إلى الحرب من أيّ وقت مضى، على رغم رسائل عدم الرغبة في التصعيد التي يتبارى أكثر من طرف دولي في نقلها. الشعور العام السائد هو أن الحرب لا تزال خياراً حاضراً، في ضوء التطورات المترتبة على عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني ورفاقه في بغداد. وهو شعور عبّرت عنه معظم وسائل الإعلام الأميركية، قبل العالمية، عبر تحليلها المستمر لميزان القوى العسكرية بين طهران وواشنطن، وبنك الأهداف المتوقع استهدافها من قِبَل الدولتين مباشرة أو عبر حلفائهما. إلا أن الحرب لا ترتبط فقط بالبعد العسكري، ولا سيما في منطقة تنتج معظم احتياجات العالم من النفط والغاز. فالمصالح الاقتصادية هي الأكثر حضوراً على طاولة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحروب، سواء بالنسبة إلى المصالح التي يجب أن تحميها الحرب، أم تلك التي يفترض أن تدمّرها، أو التي من شأنها أن تسهم في سحب الفتيل. ليس ثمة دولة في المنطقة يمكن أن يكون اقتصادها معزولاً عن تأثيرات أيّ حرب، خصوصاً الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية، أو التي توجد فيها مصالح اقتصادية غربية، وهذا يعني بوضوح أن منطقة الخليج ستكون في قلب تأثيرات المواجهة المرتقبة. وتالياً، فإن اتخاذ قرار الحرب من عدمه مرهون بعاملين أساسيين: الأول حجم وطبيعة المصالح الاقتصادية الإقليمية والدولية في المنطقة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي العالمي، والثاني مستقبل الوجود الأميركي في المنطقة.
أيّ حرب شاملة أو محدودة في المنطقة ستخلّف دماراً اقتصادياً تتقاسم أضراره دول المنطقة والعالم. ولعلّ المتأثّر الأول سيكون قطاع النفط، الذي ستخسر الأسواق العالمية منه الجزء الأكبر، وهذا يعني أن الصادرات النفطية لأهمّ سبع دول نفطية، والمقدّرة بأكثر من 417 مليار دولار سنوياً ستتوقف، أو على الأقلّ ستتراجع بنسب متفاوتة بحسب مجريات المواجهة. وبالتالي، فإن مصير 17% من الواردات النفطية الأميركية التي تأتي فقط من دول عربية أعضاء في منظمة «أوبك» سيكون في مهبّ الريح. كذلك الحال بالنسبة إلى مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات التي تُنفّذ حالياً أو يُخطَّط لتنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمُقدَّرة قيمتها بأكثر من 859 مليار دولار. فهي الأخرى ستكون معرضة لخطر التوقف أو الإلغاء، وبالتأكيد ستتوقف معها أيضاً مئات الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره وتصديره، وغالبية تلك الشركات أميركية تعود ملكيتها إلى جهات مؤثرة في صناعة القرار.
كلّ ذلك يدفع متخذ قرار الحرب الأميركي إلى حساب «خسائره» أولاً، على قاعدة أنه رابحٌ حالياً، ومن الصعب التقدير بأن أيّ حرب في المنطقة ستمنحه مزيداً من الربح. وبحسب الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، «فإن الأعوام القادمة هي الفيصل في إعادة هيكلة اقتصادات الدول وحجز المقاعد الأولى في قيادة دفة الاقتصاد العالمي، ونقصد هنا ليس فقط إنتاج النفط، بل ضمان الوصول من دون انقطاع إلى موارد الطاقة، ما يتطلّب بقاء ممرّات الشحن مفتوحة». وتضيف في حديث إلى «الأخبار» أن «منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص بلاد الشام وقناة السويس والخليج العربي، ستكون المصدر الرئيس لنفط العالم، وهذا ما شهدناه بوضوح منذ عام 2010، فقد أصبحت المنطقة مسرحاً حاسماً للتغيير وإعادة هندسة نظام عالمي جديد، وموطناً للمتنافسين واللاعبين الدوليين والإقليميين (القدامى والطامحين الجدد) الذين يتنافسون على دفة القيادة العالمية». من جهته، يشير الباحث الاقتصادي حيان سلمان إلى أن «المضائق البحرية في المنطقة تمثل مركز الاهتمام العالمي؛ فمثلاً مضيق هرمز يتحكّم وحده بنحو 32% من إمدادات النفط العالمي، فكيف الحال مع إطلالة إيران على مضيق هرمز، وإطلالة حلفاء إيران على البحر الأبيض المتوسط، وما قد يسببه ذلك من متاعب لخطط الولايات المتحدة وسياساتها، وهي مخاوف لمّحت إليها مؤخراً تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين»، مضيفاً في حديثه إلى «الأخبار» أن «كلّ حروب العالم هي حروب اقتصادية، من حيث الأسباب والجذور، لكنها تلبس لبوساً آخر، ولهذا مع نشوب أيّ حرب في المنطقة، فإن مصالح العالم كلها ستتأثر، وعلى رأسها مصالح أميركا».
لا تتوقف أهمية المنطقة اقتصادياً على الثروة النفطية والغازية والصناعات المرتبطة بها
ولا تتوقف أهمية المنطقة اقتصادياً على الثروة النفطية والغازية والصناعات المرتبطة بها؛ فالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها دول الخليج خلال العام 2018، والبالغة أكثر من 17.3 مليار دولار وفق تقديرات أممية، ستكون هي الأخرى معرّضة لخطر الضياع أو الخروج نحو دول أخرى مع أيّ تصعيد جديد، لا بل إن الرصيد الاستثماري الأجنبي المباشر الوارد إلى دول الخليج، والمتشكّل خلال 13 عاماً، والبالغ وفق تقرير الاستثمار العالمي نحو 476 مليار دولار، سيتأثر هو الآخر. فالحرب إن وقعت هذه المرة ستكون مختلفة تماماً عن سابقاتها من حروب الخليج الثلاث، ولعلّ أزمة الناقلات النفطية التي حدثت أخيراً قدّمت دليلاً على طبيعة الخسائر التي يمكن أن تتلقّاها أسواق النفط العالمية. كما أن المتضرر ليس فقط اقتصادات الخليج، بل اقتصادات المنطقة بكاملها، الأمر الذي سيتسبّب في تأزم أكبر للأوضاع الاقتصادية الإقليمية. وهنا، ينبّه الاقتصادي شادي أحمد إلى ضرورة عدم التقليل من خطورة ما أنجزته واشنطن على مدى سنوات طويلة، «فالتصعيد سوف يؤثر على المصالح الاقتصادية الأميركية في المنطقة، لكن يجب ألا نعتقد أن هذه المصالح سوف تنتهي أو تزول، لأن الولايات المتحدة استطاعت أن تنجز على مدى صيرورة تاريخية أدوات ووسائل من أجل السيطرة الاقتصادية».
ليس انسحاباً بالضرورة
عززت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأخيرة، والتي أشار فيها إلى أن بلاده لم تعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، توقعات البعض بإمكان مغادرة واشنطن المنطقة قريباً على اعتبار أن وجودها عسكرياً فيها لم يعد مجدياً اقتصادياً. توقعات تؤيّدها مؤشرات عديدة، كما يرى البروفسور السوري والوزير السابق حسين القاضي، الذي يعتبر في حديثه إلى «الأخبار» أن ما يجري تداوله يشير إلى «ملامح أزمة اقتصادية عميقة، تتبدّى من خلال العجز المتزايد في الموازنة الأميركية، وتناقص الفجوة التي تفصل بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تغيّر الخريطة الاقتصادية الدولية، وتراجع النفط والغاز بحيث لم يعد السلعة الاقتصادية الأولى. وهذا يعني تراجع الأهمية الاقتصادية لمنطقة الخليج». وبناءً على ذلك، فإن «الوجود العسكري في منطقة الشرق الأوسط غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية، إلا إذا كان مدفوع التكاليف، وهذا أمر طارئ في العلاقات الدولية. ولذلك، لم يكن التصعيد هدفاً للإدارة الأميركية ولا لغيرها من الدول المعنية. ولذا، فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن الانسحاب العسكري من العراق وسوريا هو هدف قريب للإدارة الأميركية، مع تخفيف الوجود العسكري في الشرق الأوسط بصورة عامة».
لكن، هل تحقيق الولايات المتحدة اكتفاءها الذاتي من النفط يجعلها تتخلّى عن الشرق الأوسط؟ ليس الأمر متعلقاً باستهلاك الداخل الأميركي من النفط فقط، فهناك مئات الشركات الأميركية العاملة في حقول النفط الخليجية والعراقية، والتي تحقق سنوياً إيرادات هائلة من إنتاج النفط وتكريره وتجارته، ومن المستبعد أن تتخلّى الإدارة الأميركية عن هذه المليارات. يضاف إلى ما تقدّم أن الشرق الأوسط يقع في قلب المعركة التي تقودها إدارة ترامب ضدّ كلّ من روسيا والصين. وهذا ما توضحه الدكتورة رشا سيروب بقولها «إن قراءة متأنية لقانون الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2020 رقم (116-92)، والذي تمّ إقراره أخيراً بتاريخ 20 كانون الأول 2019، يعطي بعض الدلالات على سلوك الولايات المتحدة خلال العام 2020 في المنطقة، إذ توجد فقرات خاصة بروسيا وأخرى تتعلق بالنفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، وأيضاً يتحدث عن دراسة وتحليل البيئة القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة للصينيين، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في دول أخرى»، إضافة إلى «العديد من المواد التي تعطي إشارات واضحة إلى أن واشنطن لن تنسحب من الشرق الأوسط، ولا يمكن بحال من الأحوال تخيل أن تذهب واشنطن بعيداً من دون أن تأخذ نصيباً وافراً من كعكة الغاز والنفط المكتشف، ما يتسق ورؤى ترامب الاقتصادية وصراعه من أجل إعادة الولايات المتحدة الأميركية الرقم واحد اقتصادياً ومالياً حول العالم». رؤية يتفق معها حيّان سليمان، الذي يعتقد أن «الاهتمامات الأميركية بالمنطقة لا تزال موجودة، بل على العكس من ذلك، فهي ستتزايد. ومصدر هذا الاهتمام ليس اقتصادياً فقط، فهناك عوامل أخرى متعلقة بالعامل الجيوسياسي واستثماره في محاصرة روسيا والصين وإيران، ومن ثم محاصرة المناطق الدافئة، والتحكم بأوروبا، لا سيما في ظلّ إدارة ترامب». أما اقتصادياً، «فالأهداف الأميركية كثيرة، تبدأ بالنفط والغاز، مروراً بتصدير منتجاتها إلى المنطقة، فالحصول على موارد المنطقة وتطبيق مقص الأسعار، أي الفارق بين سعر المادة الأولية والمنتجات الصناعية الناجمة عن تصنيع تلك الموارد».
وإلى أبعد من ذلك يذهب شادي أحمد، باعتباره أن «اهتمام الولايات لا يتّجه نحو السيطرة المباشرة على آبار النفط، فهذا أصبح مكلفاً جداً، بل إلى السيطرة على سوق النفط العالمي، وهذا يجعل الشركات الأميركية تكسب، سواء زادت أسعار النفط أم انخفضت، وزاد المخزون أم قلّ. باختصار، هي في حالة كسب دائمة، لأنها هي التي تسيطر على أسواق النفط». ولذلك، فمن «يعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلى عن الاستثمارات النفطية هو على حق، لكن لأن هذه الاستثمارات لم تعد تعنيها. هي تتركها لدول أخرى، وتتفرّغ لإحكام سيطرتها على الأسواق العالمية التي تحدّد الأسعار وتتحكّم في البورصات، إضافة إلى أن واشنطن تسيطر بشكل كبير على العملات الوطنية الموجودة في دول المنطقة عن طريق ربط العملات الوطنية بسعر صرف الدولار، وهذه مفارقة خطيرة جداً».
خطاب مرتقب لخامنئي الجمعة: طهران تحذّر من تفعيل الأوروبيين «آلية النزاع»
لا تزال طهران تعيش تداعيات ما بعد اغتيال قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني، وذلك في أكثر من اتجاه، أهمّها: الأزمة الداخلية الناجمة عن مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية، والتصعيد مع الولايات المتحدة، وكذلك الأزمة المتصاعدة مع الأوروبيين جرّاء الخطوة الأخيرة من خطوات التحلّل من التزامات الاتفاق النووي.
داخلياً، تسعى طهران في لملمة ذيول حادثة قصف الطائرة الأوكرانية بعد الظن أنها صاروخ «كروز» أميركي ليلة قصف الحرس الثوري قاعدة «عين الأسد» الأميركية رداً على اغتيال سليماني. الحادثة تَسبّبت بحالة حزن وغضب واسعة، فيما لا تزال الاحتجاجات المطالِبة بإيقاف المسؤولين عنها متواصلة، وذلك بعد اعتراف الحرس الثوري بمسؤولية خطأ بشري عن ضرب الطائرة. وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات، أمس، توقيف أشخاص متهمين بالمسؤولية عن الحادثة. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إنه جرى توقيف البعض مِمّن اتهموا بالاضطلاع بدور في الكارثة. في المقابل، أفادت الهيئة القضائية بتوقيف 30 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات، وأكدت أن السلطات ستبدي تسامحاً مع «المتظاهرين بشكل قانوني»، فيما نفت الشرطة استخدام الرصاص ضدّ المحتجين. من جهته، وعد الرئيس حسن روحاني بإجراء تحقيق معمّق بشأن إسقاط الطائرة، والذي وصفه بأنه «خطأ لا يغتفر».
ووسط استغلال القوى السياسية للحادثة وتداعياتها لتصفية حساباتها والاستفادة من السجال عشية الانتخابات البرلمانية، بدا المشهد في الجمهورية الإسلامية أكثر تعقيداً من أيّ وقت مضى، لاسيما مع توقيت المواجهة مع الخارج. مشهدٌ يدفع بالمرشد علي خامنئي، على ما يبدو، إلى القيام بخطوة نادرة بعد أيام، وهي إمامة صلاة الجمعة في طهران، حيث سيلقي خطبة تتوجّه إليها الأنظار باعتبارها ستحمل مواقف مهمة داخلياً وخارجياً، لاسيما وأن المرشد يندر أن يؤمّ صلاة الجمعة، وهو يفعل ذلك في الأحداث المفصلية، كما فعل إبان ثورة مصر وعقب احتجاجات «الحركة الخضراء» في إيران عام 2009.
يَندر أن يؤمّ المرشد خامنئي صلاة الجمعة
يجري كلّ ذلك بموازاة مسعى أميركي وبريطاني حثيث لاستغلال الحدث الداخلي، تجلّى في مواصلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التغريد بالفارسية، وتناقل وزارئه مقاطع فيديو للاحتجاجات، في محاولة للتعويض عن المشهد المليوني الغاضب في تشييع سليماني ورفاقه. وفي طهران، لا تزال مشاركة السفير البريطاني، روب ماكير، في الاحتجاجات، تحظى بمواقف منددة. وفيما تمّ توقيف ماكير لدقائق، ومن ثمّ استدعته وزارة الخارجية، رأت السلطة القضائية أمس أنه «عنصر غير مرغوب فيه»، في خطوة تصعيدية لكن غير كافية لطرده إذا لم تقرّر الخارجية ذلك.
خارجياً، ذهبت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، أمس، إلى خيار «آلية فضّ النزاع» في الاتفاق النووي، رداً على «الخطوة الخامسة» في إيران والتي تحلّلت طهران بموجبها من كلّ القيود في الاتفاق من دون أن تطرد المفتشين. والآلية المذكورة تعدّ مساراً دبلوماسياً معقداً قد يفضي في النهاية إلى إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران. لكن لهجة الأوروبيين بقيت منخفضة، بما يوحي بأن الضغوط هدفها التراجع خطوة إلى الوراء، في معرض الردّ على الإجراءات الإيرانية، بموازاة تفعيل المفاوضات مع طهران. مع ذلك، يتخوف مراقبون غربيون من تأثير رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي سبق وصرّح بانضمامه إلى ترامب في المطالبة باتفاق نووي جديد.
التحرك الأوروبي حظي بإدانة موسكو التي حذّرت من «تصعيد جديد». ورفضت الخارجية الروسية التبريرات لمثل هذه الخطوة، وشددت على أن الآلية «وُضعت لأغراض مختلفة تماماً»، وأن الأزمة سببها الانسحاب الأميركي من الاتفاق. أما طهران، فدعت خارجيتها، في تعليق على الإعلان الأوروبي، الترويكا، إلى تحمّل عواقب تفعيل آلية فضّ النزاع، مُهدّدة بردّ «جدّي وحازم على أيّ إجراء غير بناء». وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن بلاده هي التي بدأت بتفعيل الآلية عبر خطواتها، وعلى ضوء ذلك فإن الإجراء الأوروبي «لا يمثّل شيئاً جديداً».
بين اندفاعة متهوّرة وردّ متواضع: خياراتٌ استبعدتها إيران
لا يحتاج المراقب إلى معلومات محدّدة ليستنتج أن قرار الردّ الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد» الأميركية تبلور في أعقاب دراسة مروحة من الخيارات، لمواجهة التهديد المستجدّ والناتج من انتقال الولايات المتحدة إلى مرحلة المبادرة العملانية المباشرة ضدّ وجود إيران في المنطقة. من الواضح أن استبعاد الخيارات البديلة لم يكن إلا نتيجة ما خلصت إليه القيادة الإيرانية بعد بحث مفاعيلها، وفق قاعدة الكلفة والجدوى. وتحضر، في هذا السياق، مجموعة عناوين ومبادئ تحكم السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، وتجعلها تتمايز في رؤيتها وتقديراتها، مُتسبّبة في أكثر من محطة بإرباك رهانات أعدائها الإقليميين والدوليين.
فما هي هذه الخيارات التي يُفترض أنها طُرحت في طهران؟ ولماذا استُبعدت؟ الخيار الأول الذي ينطوي على الحدّ الأدنى من المخاطر، والذي راهنت عليه كلّ من واشنطن وتل أبيب، هو أن تمتنع إيران، ولو مؤقّتاً، عن الردّ العسكري المباشر. كان أمامها، تحت سقف عدم تحمّلها مسؤولية مباشرة، عدة سيناريوات من شأنها تجنيب المنطقة مواجهة مباشرة قد تتدحرج إلى حرب. ومن بين تلك السيناريوات، مثلاً، الردّ عبر عمل أمني من دون بصمات، والردّ عبر الحلفاء، وصولاً إلى ضرب مصالح اقتصادية، أو شنّ هجوم رمزي على هدف أميركي. كلّها سيناريوات تتّسم بكونها أقلّ دراماتيكية من سواها، ومنطوية على منسوب مخاطرة أدنى مما حمله قرار استهداف «عين الأسد». أما الخيار الثاني، فهو الاستهداف المباشر لدائرة أوسع من المصالح الأميركية في الخليج وخارجه. وهو خيار يتّسم بكونه أكثر تشدداً مما سبق ذكره، وربما لم يكن ليترك أمام الولايات المتحدة سوى الاندفاع قهراً نحو مواجهة مباشرة. فماذا يعني استبعاد هذين النوعين من الخيارات؟
في ما يتصل بالردّ العسكري الواسع، كان يمكن توقع ردّ أميركي على الردّ ربما يهدّد وجود النظام وإمكاناته الاقتصادية والعلمية والعسكرية. إذ ربّما أدى إلى استدراج مزيد من الاعتداءات الأميركية، وبمنسوب أعلى وأشدّ، وهو ما كان سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الجمهورية الإسلامية بدلاً من توقفها، ووضعها مجدداً أمام استحقاق الردّ أو التراجع تجنباً لردّ أميركي، وصولاً إلى التنازل عن ثوابتها. انطلاقاً من ذلك، واستناداً إلى أولوية حفظ النظام، جاء الردّ الإيراني كاشفاً عن رؤية محدّدة في الموازنة بين مخاطر الردّ وعدمه. أما السيناريوات المندرجة تحت الخيار الثاني (عمل أمني، ردّ عبر حلفاء...)، فهي كان من شأنها إضعاف الحافز الأميركي للردّ المضادّ، وإفساح المجال أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتجنّب التدحرج نحو مواجهة مباشرة. لكن عزوف القيادة الإيرانية عن تلك الخيارات، التي تنطوي على منسوب أمان أعلى لإيران كدولة، يعود إلى كونها غير تناسبية مع اعتداء عسكري أميركي مباشر، ما قد يوصل رسالة ضعف، ويعطي انطباعات غير صحيحة عن القيادة الإيرانية، ويوهم القيادة الأميركية وحلفاءها بأن طهران متردّدة، وتخشى المواجهة المباشرة حتى لو تمّ استهدافها، وهو ما سيرفع منسوب جرأة الولايات المتحدة على خطوات عدوانية لاحقة، فضلاً عن أنه يتنافى مع أولوية تعزيز قدرة الردع الإيرانية حتى ولو كان الثمن التدحرج نحو مواجهة مباشرة سعت الجمهورية وتسعى إلى تفاديها، لكن ليس بأيّ ثمن.
نجحت طهران في تجسيد شجاعتها، وفي الوقت نفسه حفظ مصالح الدولة
كَشَف تجنّب إيران تبنّي خيارات أكثر دراماتيكية، مع أنها كانت قادرة عليها عبر توسيع نطاق الاستهداف في العراق والخليج والمناطق المحيطة بالجمهورية في البرّ والبحر مثلاً، أنها عملت على ألّا تدفع الطرف الأميركي نحو المواجهة قهراً، بما يتعارض مع مصالحها الاقتصادية والعسكرية والردعية. كما أن هدفها كان إسقاط رهانات الولايات المتحدة على ارتداعها عن الردّ المباشر، وكسر هيبتها، ورفع منسوب القلق لدى قادتها من أن تكرار الهجمات المباشرة سيؤدي إلى ردود مباشرة أخرى، قد تكون أكثر خطورة وإيلاماً، وربما تدفع إلى مواجهة واسعة أيضاً. مع ذلك، لم يكن مضموناً تجنّب الطرف الأميركي الردّ على الضربة الصاروخية، بل كان يُفترض، وفق المصالح التي هدفت الولايات المتحدة إلى تحقيقها، أن يكون هناك ردّ على الردّ من أجل تعزيز قدرة الردع، وتدفيع إيران ثمن جرأتها على استهداف عسكري صاروخي لقاعدة عسكرية فيها آلاف الجنود. لكن هذا الاحتمال لا يتعارض مع كون الضربة راعت توفير أرضية عدم التدحرج نحو حرب مباشرة، ما دام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرى أن مصلحته تجنّب السيناريو المذكور، مع الإشارة إلى أن الخيارات الأكثر دراماتيكية كانت ستمنح الطاقم الصقوري في البيت الأبيض ورقة إضافية للتأثير في الرئيس ودفعه نحو المواجهة.
هكذا، جاء الردّ بأيدٍ إيرانية، وانطلاقاً من أراضي البلاد (في مقابل نظرية الردّ عبر الحلفاء)، وضدّ قاعدة عسكرية أميركية (في مقابل نظرية استهداف مصالح اقتصادية لبعض الحلفاء أو حتى للولايات المتحدة)، وبشكل عسكري صاروخي مباشر (في مقابل نظرية العمل الأمني)، وبصورة قاسية ومدوّية، لكن محدودة، قياساً إلى الردّ الشامل الذي يؤدي إلى مواجهة واسعة. وعليه، يتّضح أن القيادة الإيرانية نجحت في تجسيد حزمها وشجاعتها في اتخاذ القرار، وفي الوقت نفسه، حرصت على أقصى درجة ممكنة من العمل على حفظ مصالح الدولة، مع تأكيد ثباتها على خياراتها الاستراتيجية، وإيصالها رسالة مدوّية إلى أعدائها بأن أيّ استهداف مباشر لها ستواجهه عسكرياً ومباشرة، حتى لو كان ذلك ينطوي على درجات متفاوتة المخاطر. وفق المنهجية نفسها، يمكن استشراف الخيارات التي حضرت أمام ترامب وطاقمه في الردّ على الردّ الصاروخي الإيراني، والتي اختار من بينها الامتناع عن الردّ المضاد. هذا يؤشّر، بدوره، إلى إقرار المؤسسة الأميركية بحزم إيران في الردّ على أيّ ضربة إضافية، ويؤسّس لمعادلة لم تكتمل معالمها حتى الآن، لكن يُتوقع أن تحكم مجرى الأحداث اللاحقة في العراق والمنطقة.