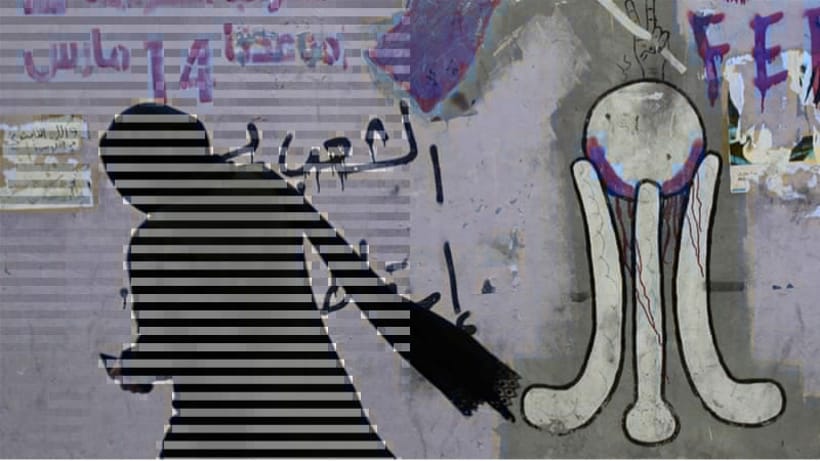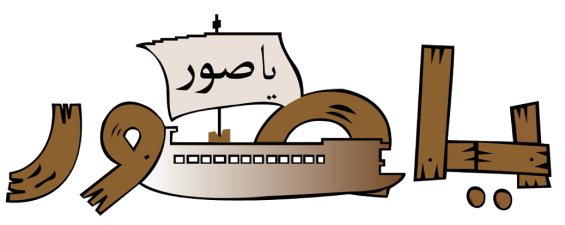9 سنوات على الانتفاضة: الأسرلة... في سبيل بقاء النظام

تسع سنوات مرّت على انطلاق انتفاضة 14 شباط/ فبراير 2011 في البحرين. تسع سنوات لم تبدّل شيئاً في عقليّة السلطة، التي لا تزال مصرّة على دسّ رأسها في الرمال، وإنكار أزماتها المتشعّبة، مضيفة إليهما مستوىً غير مسبوق من التودّد إلى إسرائيل، بل والاستعداد لتطبيع العلاقات معها بشكل علني، في ما تعتقد أنه سيؤمّن لها مظلّة بقاء أبدي بوجه شعبها. في المقابل، وعلى رغم انسداد الأفق السياسي، وضيق الخيارات المتاحة في ظلّ القبضة الأمنية المحكمة على البلاد، لا تزال المعارضة مصرّة على مواصلة نضالها السلمي حتى تحقيق مطالبها المتمثلة في الإصلاح الجذري. وما بين هذا وذاك، تتفاقم الأزمة الاقتصادية، في ظلّ ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي، وعجز الدولة عن إيجاد حلول له، حتى باتت التوقعات مجتمعةً على أكثر السيناريوات المستقبلية قتامة، اللهم إلا إذا امتدّت اليدان الأميركية والإسرائيلية لإنقاذ المملكة التي لا تتردّد في إسداء الخدمات بشكل متواصل للحليفين.
مع مرور عقدين على انقلاب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على مشروعه السياسي بذريعة «الإصلاح»، هبّت عاصفة انتفاضة 14 شباط/ فبراير 2011 في وجه الانقلاب الملكي على الدولة، ليبدأ صراع البقاء بين طرفين: شعبٌ مسالمٌ أعزل يطالب بحقوقه السياسية والمدنية، وسلطة مدجّجة بمختلف وسائل القوة. على مدى تسع سنوات منذ انطلاق «ثورة فبراير»، تعدّدت سُبل المواجهة وآلياتها، وفي المقابل استراتيجيات الحكم الفاشلة في محاولة إطلاق الرصاصة الأخيرة على رأس الحراك الشعبي المستمرّ. استراتيجيات لعلّ أبرزها وأكثرها خطورةً التحالف مع إسرائيل على أمل البقاء.
بخطىً أسرع من حوافر خيول نجله ناصر بن حمد آل خليفة، المتورّط هو الآخر في انتهاكات لحقوق الإنسان ضدّ المعارضين، يهرول الملك نحو أحضان الكيان الصهيوني، بعد نيله «وسام» احتضان بلاده لمؤتمر تصفية القضية الفلسطينية، نظير دعم بقائه على رأس نظام الاستبداد. مشروعُ أسرلةٍ بدأ منذ أكثر من عشرين عاماً، ولا يزال ممتدّاً إلى اليوم، حيث تحتشد شواهد وأدلة كثيرة عليه. من اللقاءات السرية مع كبار الحاخامات الإسرائيليين وأكثرهم تشدّداً، وكبار شخصيات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، إلى الانتقال تدريجياً إلى التطبيع الاقتصادي بأعمال مشتركة في مجالَي الاتصالات والعلاقات العامة لتلميع صورة النظام أمام المجتمع الدولي، مروراً بدخول جهاز الموساد الإسرائيلي على خطّ التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجانبين، وصولًا إلى الزيارات العلنية المتبادلة تحت شعار «التسامح بين الأديان والتعايش السلمي»، والتي يشرف عليها المستشار الخاص لملك البحرين، الحاخام الإسرائيلي مارك شناير، الذي قد يغدو مستشاراً إقليمياً لعدد من حكام دول الخليج، تنفضح شيئاً فشيئاً خيوط العلاقات مع العدو. علاقاتٌ ربما تسلك سبيلها إلى العلن في «أقرب فرصة ممكنة»، وهو ما بات يهمس به الملك بحماسة في الفترة الأخيرة، بحسب ما ينقل عنه شناير في أحاديثه المتكررة إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية.
يواجه ملك البحرين الرفض الشعبي لسياساته القمعية والتطبيعية، ولمشروع أسرلة الدولة الماضي على قدمٍ وساق، بتسخير مؤسساته القانونية والتشريعية المستحوَذ على قراراتها، لصالح تلك المواجهة. فالبرلمان البحريني، على سبيل الذكر لا الحصر، بات يشبه «الكنيست» الإسرائيلي، لناحية العمل على قطع الطريق أمام أيّ حراك معارض مطالِب بديمقراطية حقيقية، تماماً مثلما يقطع «الكنيست» الطريق على أيّ نشاط سياسي وفكري يقوده فلسطينيو الـ48، بإقرار جملة من القوانين الرامية إلى تكريس «يهودية الدولة»، والحدّ من التزايد الديموغرافي للفلسطينيين، وقمع نشاطهم السياسي التغييري. أما في البحرين، فتُشرَّع القوانين الرامية إلى «تطييف الدولة»، ودعم البنية الاستبدادية، وترسيخ مشروع التجنيس السياسي لتغيير الهوية الديموغرافية للبلاد. وقبل ذلك، يكفي هذا البرلمانَ أن رئاسته أضاعت البوصلة مبكراً، لدى اعترافها بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
المرأة... شهيدةً وشاهدة
تُقدّم السلطة البحرينية نفسها أمام المجتمع الدولي كراعية للمرأة ولدورها في الحياة السياسية، فيما في الواقع يقتصر الأمر على توظيف عدد محدود من النساء في وظائف عليا، وفق أجندات سياسية وأهداف طائفية، خلافاً لمعايير النظام الوظيفي. وعلى رغم ما يرافق الحملات الانتخابية من فقاعات إعلامية، إلا أن هذه الاستحقاقات لا تمثل فرصاً حقيقية للمشاركة في صنع القرار السياسي، في ظلّ هيمنة الأيادي الخفية للسلطة الحاكمة من خارج المؤسسات المنتخَبة.
اليوم، تخوض المرأة البحرينية رحلة نضال قد تكون الأقسى في تاريخ حكم عائلة آل خليفة للبلاد، بتقديمها فلذات أكبادها شهداء، أو تحوّلها إلى أخت شهيد أو قريبة شهيد، أو حتى شهيدة. لقد كشفت تقارير المنظمات الدولية أن اعتقال النساء في البحرين لأسباب سياسية ليس وليد الأحداث الأخيرة، بل تمّ الإقدام عليه في تسعينيات القرن المنصرم، لكن الأمور لم تصل إلى ما وصلت إليه راهناً؛ إذ تمّ اعتقال العديد من النساء لأسباب مختلفة، كوجود رسالة نصية في هاتف المرأة تدعو إلى تظاهرة شعبية أو أيّ نوع من أنواع الأنشطة السياسية، أو حتى الاستماع إلى أنشودة متعلّقة بـ«ثورة 14 فبراير» وتمّ بثها في دوّار اللؤلؤة، مركز الاحتجاجات الشعبية في العاصمة المنامة.
وتٌعدّ المواطنة فضيلة المُبارك إحدى أبرز وأوائل المعتقلات السياسيات، وقد كان سبب اعتقالها الاستماع إلى أنشودة ثورية في سيارتها الخاصة، ليُحكم عليها بالسجن أربع سنوات، وسط صمت من المؤسسات النسائية الرسمية كـ«المجلس الأعلى للمرأة»، الذي ترأسه زوجة ملك البحرين، وعددٍ من الجمعيات النسائية، إضافة إلى مجلس النواب الفاقد للكثير من صلاحياته. فضلاً عن ذلك، تمّ استهداف الجسم التعليمي والطبي ومختلف الحقول المهنية باعتقال العديد من النساء، على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات الشعبية.
إن حقوق المرأة البحرينية باتت مهدّدة اليوم، وبنسبة كبيرة، في ظلّ تفعيل الخيارات الأمنية، من دون مراعاة لأبسط حقوق المرأة التي نصّت عليها مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية. تجاوز يتجلّى بوضوح في استمرار المداهمات الليلية الوحشية لمنازل المواطنين من قِبَل القوات الأمنية، في مسلسل طويل لا تزال حلقاته تمتدّ منذ تسع سنوات، فيما تنتهي كلّ منها بصرخة امرأة مرتعبة، أو عويل أخرى جراء اعتقال ابنها أو زوجها أو أخيها، أو بكاء ثالثة لفقدانها شهيداً، أو استغاثة معتقلة تحت سياط جلّاد بلا رحمة يمارس التحرّش الجنسي.
على رغم كلّ ما تقدّم، تمكّنت المرأة البحرينية من تأسيس بنية قوية للمطالبة بالحقوق السياسية والمدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، منذ الانتفاضة التسعينية وحتى انتفاضة 14 شباط/ فبراير 2011. ولم تفعل آلة القمع سوى أنها زادت من عزيمتها وعزّزت روح المقاومة لديها.
«مواطنة» الخوف والانتقام
بحصيلة ثقيلة تصل إلى 1595 انتهاكاً ما بين شباط/ فبراير 2011 وكانون الأول/ ديسمبر 2019، يُشكّل عام 2019 علامة فارقة على صعيد استهداف السلطات البحرينية للحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير. هو واحد من أسوأ الأعوام منذ بدء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد. الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، والتي شملت 3 حالات قتل، واعتقالات مترافقة مع ممارسة التعذيب، ومحاكمات قضائية، وأحكاماً بإسقاط الجنسية، وتشويهاً للسمعة، ومنعاً من ممارسة المهنة، ودفعاً بسياسات تمييزية سياسياً وطائفياً، وتحريضاً على الكراهية والعنف، تُعبّر بوضوح عن 10 سنوات من توحّش الدولة بوجه الصحافة والصحافيين، فضلاً عن نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين.
خلال العام المنصرم، وثّقت «رابطة الصحافة البحرينية» نحو 68 حالة تمثل انتهاكات موصوفة للحريات الإعلامية والحريات العامة، من بينها، للمرة الأولى عالمياً، تجريم متابعة أيّ من الحسابات التي تعتبرها السلطات «تحريضية ومثيرة للفتنة» في موقع «تويتر». ولا يبدو القادم أفضل؛ إذ يبحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديداً لتنظيم الصحافة والإعلام، تُعدّ نحو 25% من مواده بمثابة عقوبات سيواجهها الصحافيون والمؤسّسات التي يعملون فيها. والأخطر من ذلك هو ربط العقوبات بقانونَي العقوبات وحماية المجتمع من الإرهاب. باختصار، هذا القانون هو جريمة مكتملة الأركان.
السياسات الحكومية المتطرفة أتمّت مصادرة الفضاء العام، وسلّمته إلى «وحدة الجرائم الإلكترونية» التابعة لوزارة الداخلية. ولم تقتصر مفاعيل قانون «العزل السياسي» على حرمان غالبية المنتمين إلى تيارات المعارضة من حق الترشح والانتخاب، بل شملت أيضاً محاصرتهم وملاحقتهم في الفضاء الإلكتروني وفي الندوات الثقافية. وبخلاف الكوارث المباشرة المرصودة، ساهمت هذه السياسات في رواج مخيف لخطابات الكراهية والتحريض على العنف بين أبناء المجتمع، وهو ما خَلّف ويُخلّف تداعيات وأمراضاً اجتماعية خطيرة.
إن الإصلاح الحكومي المنتظر، في ما يتعلق بالحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاحات السياسية المعطّلة، التي دعا إليها تقرير «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» (لجنة بسيوني) الصادر في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وقبل ذلك، تجاوز حالة الانتقام المستشرية في أجهزة الدولة ومؤسساتها، السياسية والقضائية منها قبل الأمنية. إن أيّ تصحيح لعمل مؤسسات الإعلام الرسمية في البحرين، وكذلك القطاع الخاص الذي تهيمن عليه الدولة، هو في العودة الأمينة إلى ما نصت عليه «مبادئ كامدن الـ12 حول حرية التعبير والمساواة»، وأيضاً في العمل بجدية على تنفيذ التوصية الأساسية في «خطة عمل الرباط»، وهي «اعتماد تشريعات وطنية شاملة لمكافحة التمييز، مع إجراءات وقائية وعقابية من أجل المكافحة الفعّالة للتحريض على الكراهية».
ولئن كانت الدولة، مؤسسات سيادية وسياسية وأمنية، تتقدّم في ما تعتقد أنها انتصارات عريضة في سحق الحريات العامة، إلا أنها لا تتنبّه إلى أن دولةً، الخوف ركيزتها والانتقام ثقافتها، هي دولة هشّة، لا استقرار فيها ولا مستقبل لها.
الدين العام... ولا شيء سواه
تواجه البحرين، منذ عام 2014، ارتفاعاً مستمرّاً في الدين العام، الذي تفيد البيانات الرسمية بتسجيله في عام 2019 رقماً قياسياً تجاوز الـ13 مليار دينار (100% من إجمالي الناتج المحلي)، فضلاً عن وجود 1.54 مليار دينار هي عبارة عن ديون غير مدرجة في رصيد الدين العام، بعد قيام جهات حكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية، وهو ما يجعل المجموع يصل إلى 14.54 مليار دينار، فيما تأكل فوائد القروض ما يقرب من 22% من الإيرادات الحكومية. هذه المديونية العامة تُعدّ، مقارنة بحجم الاقتصاد البحريني وموارده المحدودة، مرتفعة للغاية.
فالبحرين هي الأفقر في الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي (تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً)، فيما مواردها غير النفطية ضئيلة جداً، ولا تتجاوز 15% فقط من مجمل الإيرادات العامة.
عمدت الحكومة، خلال السنوات الأربع الماضية، بهدف خفض الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة، إلى إطلاق حزمة مبادرات لخفض المصروفات، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز كفاءة الإنفاق. كما وضعت خطة هيكلية مدعومة خليجياً تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. وعلى رغم حصولها على 1.7 مليار دولار من أموال الدعم الخليجي، إلا أنها لجأت (25 أيلول/ سبتمبر 2019) إلى اقتراض 765 مليون دينار بحريني، لتبلغ فوائد الدين العام في موازنة عام 2019 نحو 640 مليون دينار، في ما يُعدّ أكبر بند في الميزانية.
ويعني استمرار الوضع على ما هو عليه، في ظلّ اعتماد الدولة المفرط على النفط، أن المشكلة المالية ستتفاقم، وستخلّف تداعيات أكثر خطورة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يمكن أن يتجلّى في النتائج التالية:
أولاً: ستواجه الدولة صعوبة في سداد الدين، وستدفع تكلفة عالية لخدمته، ما يحتّم الدخول في حلقة مفرغة على حساب خطط التنمية ورفع معدّلات النمو، وبالتالي سيكون من الصعب تحقيق حياة مستقرة في ظلّ اقتصاد مزدهر يؤمن فرص عمل ودخولاً مالية كافية.
ثانياً: ارتفاع الدين العام يعني المزيد من التقشف، واستمرار الركود الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وزيادة عدد الفقراء.
ثالثاً: المزيد من التبعية للمقرضين وللدول الأخرى وللمؤسسات المالية المانحة.
رابعاً: سيفقد المستثمرون الثقة في قدرة الدولة المالية، ما يعني المزيد من الانخفاض في التصنيف الائتماني، وبالتالي تجنب شراء السندات الحكومية في المستقبل.
على أن التحدّي الأكبر الذي يواجه البحرين ليس ارتفاع الدين العام فحسب، بل هو مدى قدرة الدولة على تمويله، وبالتالي انعكاسه على ثقة المؤسسات المالية في إقراضها. ماذا يعني وجود 640 مليون دينار كفوائد للدين العام؟ إن هذا المبلغ يعني الكثير لاقتصاد البحرين، حيث يمكن للدولة بهذه الفوائد أن تنفذ مشاريع تنموية، وتعالج عدداً من القضايا الأساسية كالإسكان والتعليم والصحة والتوظيف. فعلى سبيل المثال، تستطيع الدولة بقيمة فوائد الدين العام بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، وسبعة مستشفيات، و125 مدرسة ثانوية أو إعدادية، وأكثر من 9 مصانع لإنتاج الأنسولين يمكن لكلّ منها توفير 250 فرصة عمل، وستة جسور، فضلاً عن بناء مطار جديد متكامل، وبمرافق عالمية المستوى، تضاهي تلك الموجودة في أحدث المطارات في العالم.